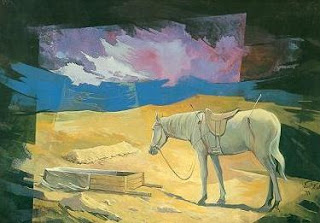لا يمكن للباحث الولوج الى آفاق العظمة عند الإمام الحسين ، إلا بمقدار ما نملك من بعد في التصور، وانكشاف في الرؤية، وسمو في الروح والذات... فكلما تصاعدت هذه الأبعاد، واتسعت هذه الأطر، كلما كان الانفتاح على آفاق العظمة في حياة الإمام الحسين أكثر وضوحاً، وأبعد عمقاً... وفي السنين الأخيرة حدث تطور فكري باتجاه قراءات جديدة للفكر العربي ألقت بأثرها على قراءة التاريخ الإسلامي وخصوص ثورة الإمام الحسين في كربلاء ، مما أدى الى المزيد من استكناه دلالاتها في الحياة السياسية والاجتماعية والانسانية..
إن المتتبع لمراحل التاريخ الإسلامي يجد الكثير من الحركات التي تبنّت الدعوة إلى تنقية الفكر والعقيدة والواقع وإصلاحه ، لكنها كانت على الدوام تقع في إشكالية الفهم التجزيئي للإسلام وفهم مقاصده ، والخلط بين الوسائل والغايات ، فكانت تكرّس واقع الجمود في الأمة ، أو تصبح مدخلاً للتطرف والفكر التكفيري وشق صف الأمة ..
والذي يلاحظه الباحثون والنقاد انه قد أدّى التركيز على عنصر المأساة التي وقعت في كربلاء، إلى اختزال تعاليم هذه المدرسة الفكرية العظيمة بعنصر المصيبة الفاجعة التي حلّت بالحسين وأهل بيته وأصحابه وغابت عن أنظارنا الأهداف التي سعى مهندس وعي النهضة الى تحقيقها حتى خيّل للبعض أن النتائج ( الموت والسبي..) التي حصلت في كربلاء هي الأهداف التي سعى الإمام الحسين لتحقيقها من أول الأمر مع أن الإختلاف بين النتائج والأهداف يجب أن يكون من الواضحات. فإن النتائج المأساوية قد صنعها المستبدون والطغاة لتعطيل حركة الإمام الحسين باتجاه الأهداف (الاصلاح والوعي الديني).
ان تأثير قضية الإمام الحسين تتجاوز زمانها ومكانها ، وهي قد أنتجت حركة فكرية ثقافية واسعة تطال مختلف جوانب المعرفة والحياة، كما قدمت منظومة مناقبية جديدة، تنبثق من روح المسؤولية والالتزام الأخلاقي، وتجلى ذلك في أخلاقيات معسكري الحادثة، حيث معسكر الإمام الحسين وأنصاره الذين دافعوا بعز وفداء وأخلاقية عالية عن الدين والمصلحة العامة، في مقابل من في المعسكر الآخر الذين سيطرت عليهم الأنا والمصالح والانتهازية على حساب ضمائرهم ودينهم وأمتهم.
فالاصلاح الذي رفع شعاره الإمام الحسين (ع) هو إحياء وتحديث لأمر أو منهج له سابقة ، لذلك يمنح الإمام الحسين (ع) هذه المسألة في نهضته بُعداً حركياً ينبغي أن نمضي في دراسة حركته الاصلاحية على هديه فنأخذ بالأهداف السياسية والاحتماعية ونبتعد عن النتائج التي ارتبطت بخذلان الناس وارهابية السلطة الحاكمة وظروفها الزمكانية..
عندما طرح الإمام الحسين(ع) مشروعه لم ينطلق في خطابه من حالة مذهبية، بل من خلال البعد الانساني للإسلام، وبخطاب إسلامي الإطار حسيني المفردة واقعي الابداع .
يقول جرهارد كنسلمان: ( إن الحسين ومن خلال ذكائه قاوم خصمه الذي ألب المشاعر ضد آل علي وكشف يزيد عبر موقفه الشريف والمتحفظ فلقد كان واقعيا ولقد أدرك إن بني أمية يحكمون قبضتهم على الإمبراطورية الإسلامية الواسعة).
ولذا فقد كان الامام الحسين إنسانياً حتى في نظرته للثورة وتفاعله معها وتفعيلها، فقد رفض ان يخضع خضوعا كليا للحتمية الاجتماعية والتاريخية لانه ربط الحتمية التاريخية بالاهداف التي وضعها جده الرسول الخاتم (ص)، وقد ربط الحتمية بالقيم الاخلاقية والدينية، فولادة الإمام الحسين عليه السلام كانت ولادة منهج الثورة في حركتها نحو تحقيق الأهداف الانسانية الكبرى ، كما أن بانوراما الاستشهاد هي آلية الثورة في تجاوزها لآنية الحدث وانفتاحها على كونية الفكر ولما يجب عليه ان تكون الامة..
( من كان باذلاً فينا مهجته وموطّناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا, فإني راحل مصُبحاً إن شاء الله تعالى ) .. بهذه الصيحة أطلق عوامل الإمتداد والتوهج وينحو بحركته النهضوية الكبيرة منحىً رساليا تعبدياً يسير وفق منهج يرسخ علاقة الانسان بالخالق في مجمل حركته في الواقع السياسي والاجتماعي ..وهذه الخصوصية المتأصلة في الحسين(ع) تولدت من عوامل أهمها؛ أنها كانت عملية ابداعية تكاد تتجاوز قيمة الشكل الفني لتصبح رؤيا مستقبلية للحياة، فقيمة التحرك الحسيني والخروج لـ( الحياة ) و( الفتح ) تكاد لاتختلف عن عملية الخلق أو النشأة الاولى ليس فقط باعتبارها إضافة نوعية للحياة، ولكن باعتبارها تفسيرا فلسفيا لغائية الوجود...وعندما يكون هذا الانسان إماما معصوما يمثل استيعابا كليا للوجود، كما يمثل استيعابا كليا لحركة الحياة.
وكان من ابرز الصفات المتجلية لدى نخبته التي تحركت معه وفق منهج إختيار وترشيح دقيق ؛ الصدق في الحركة الاصلاحية، والاخلاص في الثورة من دون ان تشوبها اغراض ومطامع دنيوية اخرى، والزهد في المناصب السياسية والدنيا، والتفاني في سبيل القائد.. ويجلى ذلك فيما أبدعه العباس وزينب وحبيب وجون وعابس وبرير وغيرهم والتصريحات التي انطلقت من افواه الرجال الذين كانوا بركب الحسين(ع) كمسلم وزهير وعلي الأكبر والقاسم وآخرين . وهذه المكرمات والصفات التي لازمت الحسين واهله واصحابه، وهي من العوامل المهمة في اضفاء صفة الجذابية على تلك النخب الطيبة ..
أما مفردات خطابه السياسي فنراه يستبطن مشروعاً تحريكياً وتفجيرياً لإرادة الإنسان وضميره الذي استبدلته الاجهزة الحاكمة بعضوٍ آخر لا نبض فيه ولا حركة ولا طموح . مركزاً على فرصة الخلود والرجوع الى الحق وتصويرها على أنها فرصة بيد إنسان ذلك العصر وكل عصر.. والمطلوب منه أن ينظر الى نفسه نظرة موضوعية لا تجزيئية, ويرى موقعه من حركة التاريخ وسير أحداثه, ويعي هذا الموقع وعياً عملياً يدعوه إلى البذل والتضحية ونكران الذات ليتحول فعله الى إرادة جماهيرية فاعلة تستنزل المفهوم إلى أرض الصراع وواقع المواجهة, ليتحرك (مفهوم الإرادة) على شكل واقع قيمي معطاء يدير كفة الصراع باتجاه طرف الحق والخير والفضيلة.. خلافا لأولئك متذبذبي الارداة, محدودي العطاء, مشلولي القدرة على التصميم, فانهم لن ينالوا شيئاً من هذا الفتحّ الحضاري العظيم الذي لا يزال يدوّي في عالم الخنوع رمزاً لكل الأحرار والرساليين.. وهذه هي الفلسفة التي حاولت أدبيات النهضة الحسينية أن تركّزها في وجدان الامة وذهنيّتها من خلال الفعّاليات المختلفة لرمزها الشهيد على أرض كربلاء.
فالخطاب الحسيني كان يمتح من عناصره الزمنية أي من بؤرة الصراع نفسها ففي زمن الإمام الحسين كانت القيادة الشرعية مشخّصة والحق واضحاً, إذ لم تكن لعبة خلافة يزيد لتنطلي على ابسط أفراد المجتمع, لما رأوه من نزقه وطيشه واستبداده, ولكن الأمة كانت مبتلية بمرض آخر وهو ضعف الارادة الذاتية وضمور قدرة الفرد على اتّخاد القرار الحاسم, نتيجة الترغيب والترهيب اللذّين كانت تمراسهما السلطة بحق الشعب.. فتولى الإمامة وهو يجد أمامه أمة خائرة في إرادتها متميّعة في ضميرها, ذليلة في موقفها, تلهث وراء المصالح الشخصية أو سبل الحفاظ على حياتها.. وحينما يبلغ الاعتداء حد تشويه ملامح هذه الرؤية وضياع رسمها بشكل تام أو استبدالها برؤىً وضعية غير معتمدة على خلفية شرعية, يتحتم على الرساليين أنّ ينطلقوا لازاحة التشويه الملامحي واعادة بناء الرؤية عبر اطروحة تطبيقية تعيد لها نصابها الواقعي.
وبما أن تشويه هذه الرؤية ليس نظرياً فالمطلوب ـ حسب التشخيص الحسيني ـ ليس إلقاء المحاضرات أو تبيين المفاهيم والتصوّرات, بل المطلوب هو فعل يهزّ ضمير الأمة ويزلزل سكون الواقع ويبعث في الاجساد الميتة ـ بفعل التضليل الدعائي للسلطة ـ الرغبة والنزعة إلى تغيير الواقع واستبدال مفاصله الشوهاء.. وذلك عن طريق تحريك الإرادة الذاتية للإنسان المسلم واعادة محوريتها في صنع الحدث وتحويل مسار التاريخ بالاتجاه المثمر لخير الإنسانية.. فالمطلوب إذاً لعلاج الواقع ـ حسب تحليل الإمام (ع) ـ هو التغيير الذي يسير وفق إيقاع خطى قافلة الإمامة والقيادة الشرعية, ليكون التغيير مقدمة نحو تحريك الانسان وارادته كي يستقبل عهد التغيير الشامل والانتصار الاخير للارادة الالهية ..
والدليل على هذا الربط أن الإمام الحسين كان يطلق على خروجه وحركته (فتحاً): (ومن تخلّف عني لم يبلغ الفتح) ، مع أنها تفضي إلى الموت والشهادة, خلافاً لفهم عبد الله بن جعفر الذي كان يراه هلاكاً!
وكانت نتائج الوعي الحسيني تتوزع على محورين أساسين ؛
وعي الذات : حيث كانت أغلب الشخصيات- فردا أو مجتمعا- لا يعرفون حقيقة ذواتهم.. فهناك في الواقع مستويان من الشخصية، الشخصية الظاهرية والشخصية الحقيقية ،الشخصية الظاهرية هي الشخصية التي تظهر على السطح في الظروف الطبيعية والأجواء الاعتيادية ،أما الشخصية الحقيقية فهي تلك الجوانب الخفية من الشخصية التي لا تظهر إلا في الظروف الاستثنائية الخاصة.. وهذا هو الخطأ التاريخي الذي وقع فيه المجتمع آنذاك فقد كانت معرفة هذا المجتمع بذاته محدودة بشخصيته الظاهرية المحبة والمرتبطة بالإمام الحسين والراغبة في الدفاع عنه والتضحية لأجله ، ولكنه كان يجهل شخصية الحقيقية والتي حقيقتها الضعف والخوف والحب المحدود للإمام الحسين .
وكانت نتيجة هذا الجهل المطبق بالذات الوقوع في أكبر خطأ تاريخي عرفه الإسلام ، وذلك عندما صاغ أهدافه وتطلعاته السياسية بإقامة الحكم الإسلامي بقيادة الإمام الحسين (ع) بناء على شخصيته الظاهرية، فوجه كثير من رجالات الكوفة ومن حولها الدعوة المؤكدة والمتكررة للإمام الحسين بالقدوم لهم ، وقدموا الوعود المغلظة والمشددة بنصرته والصمود معه حتى الشهادة ، وهو ما كان مخالفا لما حصل منهم لاحقا ، إذ أسلموا الإمام الحسين للموت وتركوه وحيدا وغريبا ومحاصرا ، يستغيث : " ألا من ناصرا ينصرنا " فلا يجد منهم إلا التخاذل .
أما المحور الثاني فهو وعي الواقع: حيث كان هناك قطاع من المسلمين ما زال يعاني خللا في تشخيص الواقع وظروفه الموضوعية ، وتحديد اتجاهاته وتقييم شخوصه . فأين هو الحق وأين هو الباطل ؟ ومن هو يزيد ومن هو الحسين ؟ وفي الحقيقة لا يمكن ادراك المغزى العميق لماتمثله النهضة الحسينية من الوعي بالقدرات التنظيمية الهائلة في رص الواقع الـشعبي ، وتأليفه في جماعة عضوية متطابقة ، الا بمعرفة الوضع السياسي ، وبشاعة الارهـاب الـذي كـانـت تـمارسه السلطة ضدهم ، ولمحات سريعة تكفي لاعطائنا مدلولات عن معاناة الشعب السياسية والامنية ، والامكانات الهائلة التي وفرتها النهضة الحسينية في إعادة بناء الكتلة الاجتماعية ووعيها بواقعها..
والنتيجة أننا كمسلمين وكبشر تواجهنا في الحياة وفي كل جيل من أجيالنا مشاكل وتحديات في مجال الحرية والكرامة والفكر والسلوك ، فقد نُبْتلى بالّذين يريدون فرض العبوديّة والذلّ والتبعية علينا في حياتنا العامّة والخاصّة، وقد تواجهنا في الحياة قضيّة العدالة في مسألة الحكم والحاكم الّذي يفرض علينا الظلم، في ما يُشَرِّع من قوانين، أو ما يتحرَّك به من مشاريع، أو ينشئه من علاقات ويقيمه من معاهدات وتحالفات.. وهذا ما يبعث فينا ضرورة تفعيل الدعوة إلى القراءة الجديدة لأحداث كربلاء حتى يمكننا أن نخرج أكثر وعياً و فهماً لحركة الجماهير وطبيعة الأدوار التي قاموا بها والتي تُشكّل لنا المرشد والموجّه في عملنا السياسي والإجتماعي والثقافي.. وهنا نحن بحاجة إلى عاملي العقل والعاطفة لصياغة هذه الخلفية، بحيث يكون العقل كالمسطرة الحازمة والدقيقة في الفصل بين معقدات الأمور، وتكون العاطفة كالشحنة المكثفة من الطاقة التي تدفع الإنسان للصمود أمام الآخرين..